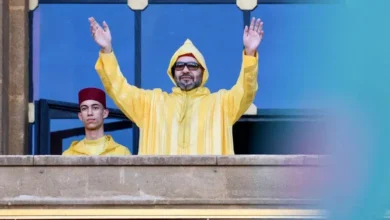حوار مع: حسن البقالي
حاوره: أمجد أبو عدنان مجدوب
* الانواع السردية العربية كثيرة لكنها لم تستطع تشكيل نص التلقي الذي نجح بالرواية ذلك ابتكار الغربي لكن الملاحظ هو استفادة الروايه من مختلف الانواع التي هي من ابداع الانسان العربي كالملحة واللطيفة والخبر والتوقيعات والنكتة والقصص القصيرة جدا
كيف تفتق مشروع الكتابة القصصية لديكم من خلال هذه الظلال؟
_ كي يزدهر نوع سردي ما في بلد معين، ينبغي أن تتوفر العوامل المساعدة. وذلك ما توفر للرواية العربية في مصر والشام خلال المنتصف الثاني من القرن 19 والأول من القرن20، من تلاقح ومثاقفة مع الأدب الغربي، وعوامل نهضة، ومحفل للتلقي باتت الرواية لديه موضوع طلب. أذكر أن عبد الله العروي قال يوما بأننا لسنا مجتمعا للرواية، في الوقت الذي كان يُعتقد فيه أن الشعر ديوان العرب. لكن الوضع الحالي يبدو لصالح الرواية وضد الشعر، ويمكن الجزم بأن الجوائز والتحفيزات لعبت دورا مساعدا في الإقبال على الرواية التي هاجر إليها شعراء وقصاصون وساهموا في تقديم نماذج مشرفة. وعموما فالأدب الجيد، من أي نوع كان، يجد متلقيه. الرواية هي كيس الأدب العميق الذي يسع كل الأشكال التعبيرية الأخرى ويدمجها في نسيجه السردي، بحيث تتضافر الموتيفات وتتنامى الأحداث على خلفيات متعددة من تشكيل وسينما وخبر ورسائل ومقال… أما بخصوص ما قدمته لحد الآن من منجز قصصي، فالأكيد أنه استحضر هذه المعطيات في زمن أو آخر من تجربتي. لقد حاولت أن أستفيد دوما من التجارب الكتابية الناجحة، وضمنت بعض ملامحها فيما قدمته، بشكل يجعل المتناصات تندمج تماما في النص بإسمنت مسلح وشاعري هو اللغة، وبحيث تشكل المكونات كلا موحدا يسابق الحيز الفضائي إلى نقطة النهاية وإحداث الأثر. والرواية الوحيدة التي كتبت لحد الآن سلكت فيها نهجا تجريبيا بحيث جعلت بناءها بناءين، واحدا كليا للرواية، والآخر للقصة، وبشكل يخول للمتلقي بان يقرأ الفصل الروائي كما لو أنه جزء من كل، أو نص مفرد مكتف بذاته. بعد ذلك خضت في مجال القصة القصيرة جدا بمجاميع متعددة حاولت تنقيط أشياء العالم في تشذرها وتشظيها ولحظاتها الخاطفة
* لعل التجريب في الروايه مفهوم واسع وهو مصطلح حديث لكن كل فئة تفهم وتجيب وتمارسه حسب تصورات معينه ما هو التجريب الروايي حسب رايك؟
_ اعتقد بأن التجريب ابتدأ مع جيمس جويس ومارسيل بروست، بتكسير خطية الزمن واعتماد الزمن النفسي المتفلت، ثم مع المدرسة الجديدة، مع ناتالي ساروت وألان روب غرييه وميشيل بوتور، بإزاحة الإنسان عن مركزيته في الكون، وإعادة الاعتبار لأشياء العالم.
ما يهم أن التجريب في الغرب أتى ضمن مسار تاريخي للرواية عرفت أوجها في القرن 19، بينما عرفت الرواية المغربية التجريب بشكل مبكر جدا، مما أفرغها من عمق التاريخ وسند التراكم وأفقدها محفلا للتلقي يؤمن بها ويقبل عليها. هكذا، ولما يستو عود الرواية المغربية، تتبعنا خلال السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي صدور روايات بشخوص ضبابية ولغة مشحونة، حاجز الثلج لسعيد علوش، ابراج المدينة لعز الدين التازي، رجولة وما الخبر لاحمد لشكر، وروايات احمد المديني الأولى…
ويبقى التجريب خلخلة لمواضعات النوع الأدبي المتعارف عليها، نبشا خلف آفاق أخرى للإبداع ضمن نفس النوع أو اختراقه بالشكل الكافي الذي يتيح ظهور نوع جديد يصارع بدوره لأجل تسييج مجاله بمواضعات جديدة تحتاج إلى أن تخلخل. لكن التجريب في النهاية بمثابة مشي على الحبل يحتاج إلى كاتب حاذق كي لا تتفلت مياه السرد من بين أصابعه
* ظهرت نقديا كتابات تصف نصوصا سرديه على انها نصوص روائيه ذاتيه واغلب اعمال الروائيين الاولى فيها حيز كبير من الذات والتجربه الفرديه الحقيقية كيف كيف في نظرك التعامل مع العنصر الذاتي في العمل الروائي ؟
_ الشعرة التي تصل الرواية بالسيرة الذاتية دقيقة جدا. فالرواية من أي مذهب أدبي كانت، لا بد أن تحمل بذور عناصر ذاتية يوظفها الكاتب في مفارق النص، إما تركيزا على شخصية روائية محددة أو يفرق دمها على القبائل. فإيما بوفاري هي فلوبير في النهاية، وضمير المتكلم يضج بالذوات.
وبالمقابل تتعرض السيرة الذاتية لاجتراحات من قبل الكاتب خلال استعادته للعناصر الحياتية تجعله يقول أو يخفي ما يريد ضمن عملية مونتاج واعية. إن البحث عن الزمن المفقود لا يتم عبر الذات فحسب. وواضح أن النصوص الروائية الأولى سواء على الصعيد المجتمعي العام أو الفردي كثيرا ما تميل إلى اعتماد الجانب السيرذاتي بوصفه مادة جاهزة تساهم في مراوغة ارتباك البدايات. هكذا برزت نصوص مثل زينب لهيكل، أو عصفور من الشرق لتوفيق الحكيم، أو موسم الهجرة إلى الشمال للطيب صالح، أو لعبة النسيان لمحمد برادة في مفترق الطرق ما بين السيرذاتي والتخييلي.
ثمة حيلة فنية التجأ إليها بعض الكتاب حين وسموا كتاباتهم بكونها سيرا تخييلية، معلنين بذلك عن تكسيرهم للحدود بين النوعين الأدبيين، واعتمادهم على عناصر ذاتية، مع التحرر من أي التزام “تاريخي”، وتحت هذا التوجه تندرج أعمال عبد القادر الشاوي على سبيل المثال.
* يشكل العنوان إحدى أهم العتبات المركزية للنص أو للكتاب ، والعنوان في عالم السرد القصصي القصير جدا يعتبر – على خلاف أنواع أدبية كثيرة – جزءا تكوينيا حدثيا في البناء السردي. كيف ينظر القاص حسن البقالي إلى هذا المكون؟
_ أكيد أن الدراسات النقدية الحديثة تركز على دراسة العتبات والمتناصات والنصوص المتخللة، لكن بخصوص القصة القصيرة جدا، لي رأي في الموضوع سبق أن عبرت عنه، هو أن العنوان ليس بالأهمية الكبرى إلا في النادر، حين يكتب النص بمكر فني يجعل العنوان مظلة تغطيه بقدر ما تعري المعنى أو تخلق مفارقة عميقة وثرية بالدلالات والانزياحات.
ما عدا ذلك أرى بأن المئات، الآلاف من عناوين القصة القصيرة جدا هي عناوين باهتة مكونة في الغالب من لفظة واحدة، يستعجل المتلقي تركها وولوج محراب النص. إنك حين تتجول في حواري المدينة القديمة بفاس أو مراكش مثلا، قد لا تثيرك بوابة بناية ما، تجد أنها متقادمة وكالحة القسمات، لكنك بتخطيها تجد نفسك إزاء رياض طاغ بالحسن والجمال وحسن التنسيق.
النص ينبغي أن يكون ذلك الرياض
وللباب أن تكون خادعة
* اشرتم الى التحول الذي طبع كثير من الفئات الادبيه حتى اني كنت ا كنت انوي الكتابه البحثيه الجامعيه عن الشعراء التسعينيين لكن يوجد في الواقع معطيات كثيره حالت دون دون تحويل فكره الى المشروع واهم عنصر هو تحول كثير من الشعراء والادباء الى كتابه السرد القصص ي والروائي امر جعل جعل الكوكبه تصبح افرادا لا جامع بينهم عكس ما كان اعوام 1997 1998 1999
السؤال السؤال ما رايك في قضية التحول هذه سواء من الشعر الى السردي او الى النقد؟
_لدى المبدع دوما رغبة في التجاوز، تجاوز الذات وتجاوز البراديغمات والحقول ومجالات الاشتغال. إنه، في الوقت الذي ينتمي فيه إلى نوع أدبي معين، ينزع إلى نوع آخر. هو قلق الخلق الدائم والتوتر الذي لا محيد عنه. فالاستقرار ليس سمة الكاتب، ما يميزه هو الترحال، خصوصا في الزمن الحالي حيث تجسير الهوة بين الأنواع وتكسير الجدران. وقلة من الكتاب من بقي وفيا لنوع أدبي واحد يشد عليه بالنواجذ ولا يرضى عنه بديلا. لقد كتب بورخيس القصة القصيرة، ولم يهف يوما الى كتابة الرواية لأنها لا توافق نظرته إلى العالم، وكذلك يفعل بوزفور عراب القصة المغربية. على أن العديد من الشعراء هاجروا نحو السردي من قصة قصيرة وقصيرة جدا ورواية، كما هاجر الكتاب من الإبداع إلى النقد، والنقاد من النقد إلى الإبداع. في مرحلة ما قيل إن الناقد هو مبدع فاشل، ولست أدري إلى أية حجية استندت هذه المقولة. الأكيد أن الشخصية الإنسانية عموما جوانب متعددة، والمبدع لا يكتفي في الغالب بقبعة واحدة، يبقى السؤال عن العطاء فقط
*قصة العزف ضمن مجموعتك “الرقص تحت المطر”
فيها علامتين هامتين:
تعثر ……………واللامتوقع
والكتابة التخييلية السردية القصيرة جدا ميزتها انها انحراف في تتابع الأحداث بمعنى ” التعثر” وبمعنى ” اللامتوقع”
لنتذكر المقامة المجاعية للهمذاني
فبعد سرد وصفي ومبالغة في إشعال شهوات الجائع (حتى القارئ جائع) يفاجئ الجواب الجميع الكائن الورقي السردي والكائن القارئ الفعلي ” لو كانت !!”إذا يتعرض الجائع لعملية إلهاء بالتخييل ،وعل هذا ما يقع للقارئ أيضا
حسن البقالي يتقن هذه اللغة لنتذكر قصة ” الزبون” وقفلتها الحارقة ” انفجر”
مامدى صدق هذه الأوصاف في نظرك كقارئ لحسن البقالي القاص؟
_ نعيش في زمن للايقين، تقلصت فيه المسافات، لكن ازدادت العزلة وخفت الإيمان بالقضايا الكبرى والمؤسسات التقليدية، وبالتالي لم تعد ثمة أرض ثابتة يطمئن الفرد إليها، ويمشي بخطوات واثقة. ثمة دوما منعطف بالقرب أو مطب وثمة مصادفات تضرب أي حساب عرض الحائط. ولا غرو أن تحمل القصة هذا الهم. إنه هم حضاري وهم تقني أيضا، يعود في جزء منه إلى مواصفات وشروط الإنتاج الفني للنص القصصي، وخصوصا القصة القصيرة جدا.
كان يتم الحديث في زمن قريب عن تكسير افق المتلقي. الآن، بخصوص القصة القصيرة جدا، يتم الحديث عن القفلة )أو الخرجة كما يفضل الأستاذ د. مسلك ميمون تسميتها( القفلة المدهشة التي تنتج مفارقة ما، وتفاجئ المتلقي بمسلك جديد غير متوقع. ذاك ما وقع في قصة “زبون” على سبيل المثال. هناك شاب حليق )الأرجح أنه حلق شعره في الساعات الأخيرة تقية( يتوجه نحو المقهى، وبالداخل امرأة همها تصيد الرجال. إن القصة تنسرد من زاوية نظرها. تتبع الشاب قادما وتتوقع ما سيأتي: سيقع في أحابيلها حتما كالآخرين، ويقضيان ساعة متعة. هي لا تعلم أن متعته مع الحور العين، ولن تعلم ذلك بالتأكيد، لأن الشاب )الانتحاري(، بمجرد بلوغه المقهى ضغط على زر الانفجار.
تحدثت عن المقامة المجاعية. هي تقوم على الإيهام. واليأس المطبق سهل خلق الرغبة من جديد. أذكر في هذا الإطار قصة عن “ساحر مرجإ” لبورخيس، يذكرها جان ريكاردو في كتابه “قضايا الرواية الحديثة”. هناك إيهام وسحر ينطلي على الشخصية الرئيسية )العميد القادم من سانتياغة لتعلم السحر(، وعلى المتلقي أيضا بنفس الدرجة.. سحر الساحر وسحر الكاتب، فالعميد يتسلق ضمن التراتبية الكنسية من أسقف إلى رئيس الأساقفة فكاردينال ثم بابا.. تمر على ذلك أشهر وسنوات، يتنكر فيها لوعوده ل”معلمه”. على أنه يفاجأ في النهاية بأنه لم يبرح الغرفة تحت الأرضية تماما، وأن المسافة الزمنية التي قضاها لم تتعد مسافة انتظار وقت الغذاء
هل أنا قارئ جيد لعملي؟ لست أدري.
* لو سألتك عن الأعمال السردية التي كونت ذائقتك ورؤيتك في الكتابة، ماذا تكون؟
– أخي الذي عشت في كنفه صغيرا بعد وفاة والدي رحمهما الله كان له فضل اقتناء الأعداد الشهرية لمجلة العربي الكويتية. ويمكن الجزم بأن هذه المجلة كانت أول المؤثرات، بما كانت تتيحه من قصص قصيرة عربية وعالمية. بعد ذلك سيأتي دور الروايات المشرقية، المصرية على الخصوص، يوسف السباعي، عبد الحليم عبد الله، إحسان عبد االقدوس ونجيب محفوظ طبعا.. ولعل رواية “السراب” كانت مدخلي إلى تجربة الكتابة. هذا بالإضافة إلى أعمال عربية وعالمية أخرى: أعمال أحمد المديني الأولى، روايات زفزاف، عبد النبي حجازي )حصار الألسن(، هوميروس )الإلياذة(، كازانتزاكي )زوربا اليوناني ..
* يقبل شباب شبابنا شبابنا وشاباتنا على قراءه السرد وخصوصا الروايه من التي تقرا نجد روايات طويله كتبها مشارقه غالبا مترجمه عن الفارسيه او تركيا او او لغه اخرى ونجد الخيال الطوباوي و قصص الحب والتصوف هل هذه هي مواضيع الاثيره في في التلقي المعاصر لشبابنا ام ان هناك اسرارا اخرى لا نعرفها اننا نتوهم اننا نعرف من نكتب اليهم ولهم ولا ولا ادري حقيقه هذا الامر حبذا لو اجد لديك تفسير من هذه الظاهره الخاصه ومنظورك
– هذا يعيد طرح السؤال التقليدي: لمن نكتب؟ هل لدينا دراسات مهمة ومستفيضة في سوسيولوجيا القراءة تتيح للكاتب معرفة متطلبات وانتظارات كل فئة عمرية أو شريحة اجتماعية أو مهنية، كما يحدث ذلك بخصوص المنتوج الاقتصادي؟ أليس للكاتب في النهاية نفس الهدف: أن ينتشر أكثر ويبيع أكثر، وتصير الكتابة مهنة تدر دخلا محترما، عوض الانشغال بمهنة أخرى محايثة ل”حرفة” الكتابة التي لا تصيب أحدا إلا أفقرته؟ ثمة استثناءات طبعا. لكن من جهة أخرى هل مست الأعمال المنتشرة جماهيريا والتي طبعت منها ملايين النسخ، هل مست كل الشرائح والفئات؟
من هنا لا حرج على شبابنا من أن يقرؤوا قصص الحب والخيال وحتى الروايات المسقية بماء الورد، شريطة ألا يبقوا حبيسي هذا النوع من الأعمال. لقد تربينا أيضا على قصص الحب والمغامرات المصورة وأعمال جبران والمنفلوطي. ومروحة الاختيارات واسعة جدا، كما أنها تأخذ منحى تدرجي ارتقائي. فليقرؤوا إيليف شافاق أو أحلام مستغانمي، أو غادة السمان وعبد الرحمان منيف، أو الأشعري وعبد الإله عرفة، أو جورج أمادو وموراكامي… إن الأسماء ترد هنا اعتباطا، فالذائقات تختلف والمرجعيات القرائية كذلك، ونحتاج قبل هذا وذاك إلى إحداث ثورة ثقافية تنهض على حب الكتاب وتداوله وحسن تسويقه إعلاميا. هذا يساعد حتما على الفرز وتكوين مجتمع قارئ وواع بما يقرؤه.
* حضرت المدينه في ابداع سردي المغربي كثيرا حتى اما الاعمال السرديه شهيره عرفت بهذا الوسم انت تسكن مدينه صغيره لكنها عرفت بمبدعيها ما شكل حضوري تيفلت في ابداعيك
– تيفلت المدينة
تيفلت الفضاء حاضرة بوضوح في مجموعتي القصصية القصيرة جدا “قط شرودنجر”، بسوقها ومقاهيها وشوارعها وأهلها. أكيد أن القصة القصيرة جدا لا تتيح إلا ومضات خاطفة عن كل ذلك، لكن روايتي التي لم تكتمل بعد تستحضر الكثير من واقع المدينة وتاريخها القريب..
* القصه القصيره انثى والروايات انثى والكتابه انثى لكن القلم ذكر والحبر ذكر هذه صفات نسبيه طبعا طبعا في الفرنسي نجد القمر مؤنث والشمس المذكر ولكن اذا اذا ثقافيه عن سؤالي هو كيف يرى حسن البقالي الى المؤنث و المذكر في الكتابه؟
في الواقع لم يسبق لي ان طرحت على نفسي هذا السؤال، فالتذكير والتأنيث ارتبط في الكثير من السياقات بالكتابة النسائية، عندما التفت الرجل الذكر الذي ألف أن يجعل من المرأة الأنثى موضوعا لكتابته، ليجد نفسه موضوعا لكتابة نسائية تنبش في قضايا المرأة والمجتمع من منظور نسائي.
إن الملح هو السائل المنوي الذي قذفته السماء في ارتباطها بالأرض. هذا بالطبع لأن السماء ciel بالفرنسية مذكر، بينما الأرض terre مؤنث. اما في العربية فكل من السملء،والأرض مؤنثان، وإذن، إذا كان الملح سائلا منويا، فيجدر البحث عن الذكر صاحب الفعلة الحقيقي، عبر التفكر في الأجرام السماوية
* الكتابه ليست الا استرجاع الذاكره ما تحزن في هذه القولة؟
_ الكتابة تغرف من كل الطنجرات، فهي تنسج خيوطها ما بين الاسترجاعي والاستباقي، مستعينة بالذاكرة وبالخيال، والمكتوب والمعيش والشفهي.. أكيد أن بعض الأنواع أكثر اتكاء على الذاكرة مثل السيرة الذاتية، لكنها عموما استقصاء أو استبطان.. عين على الخارج أو الداخل.. تذويت للعالم أو موقعة للذات ضمن أشياء العالم.
الكتابة في النهاية حفر في كل الاتجاهات بحثا عن قنديل يضئ المساحات